01/07/2025
ثقافة و فن 14 قراءة
قراءة في كتاب..الهوية المفقودة والانتماءات المتعدّدة
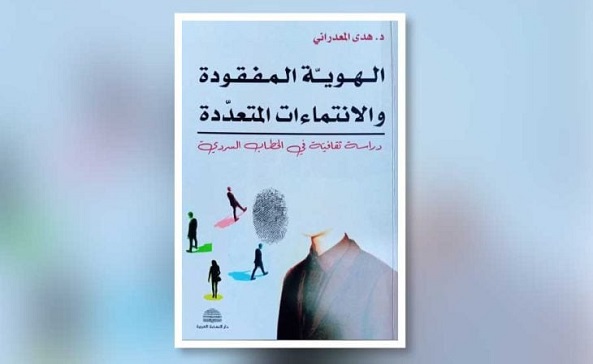
الاشراق
الاشراق | متابعة.
يشكّل سؤال الهوية أحد الأسئلة التي تطرحها الرواية العربية، في هذه اللحظة الروائية، لاسيّما تلك المحيلة إلى مجتمعات متعدّدة داخلياًّ، أو هي على تماس مباشر مع مجتمعات غربية خارجياًّ، كالمجتمع اللبناني الذي تتعدّد فيه الانتماءات، وتبقى الهوية مشروعاً قيد البحث. هذا السؤال ترصده الباحثة والأكاديمية اللبنانية هدى المعدراني في كتابها «الهوية المفقودة والانتماءات المتعدّدة»، الصادر حديثاً عن دار النهضة العربية في بيروت، وتتقصّى تمظهراته المختلفة في أربع روايات لبنانية، هي: «شريد المنازل» لجبّور الدويهي، «في بلاد الدخان» لهدى عيد، «قيد الدرس» للنا عبد الرحمن، و»فاقد الهوية» لحنان فرحات. وتخلص، بنتيجة الدراسة، إلى أنّ الروايات الأربع تختلف في ما بينها في التمظهرات المرصودة، وتتّفق في «رفض الآخر المختلف، واختصار الهوية بالبيانات الموجودة على بطاقة، تمنحها الدول لبنيها، بوصفها أيقونة تجسّد الانتماء إلى ما هو مكتوب عليها، فتتحوّل إلى جدار أخلاقي، وامتحان أمني، مسلّط على رقاب السكّان، الذين لن يكونوا مواطنين من دون هذه البطاقة»، على حدّ تعبيرها.
بالدخول في الدراسة من عتبة العنوان، يتبيّن لنا أنّ الباحثة تميّز بين مصطلحي الانتماء والهوية، في الحجم والعدد والحركة، فالأوّل جزئي ومتعدّد وثابت، بينما الثاني كلّي وواحد ومتغيّر. والعلاقة بين المصطلحين ليست علاقة تكافؤ، بل هي علاقة يتفاعل فيها الجزئي في إطار الكلي ولا يختزله. وهو ما يؤكّد عليه المتن ببحوثه الأربعة.
يقع الكتاب في تقديم ومقدّمة وأربعة بحوث وخاتمة، تشغل مجتمعة 230 صفحة، ويتفاوت عدد الصفحات من بحث إلى آخر؛ ففي حين يمتدّ البحثان الأول والثالث على مساحة 60 صفحة، لكلٍّ منهما، يقتصر عدد الصفحات في كلٍّ من البحثين الثاني والرابع على 40 صفحة، على أنّ هذا التفاوت الكمّي لا يعكس، بالضرورة، تفاوتاً نوعياًّ بين البحوث. وبمعزل عن هذا التفاوت، فإنّ المعدراني تعتمد في دراستها المنهج الثقافي، وتستعين «بعلم النفس والاجتماع ونظرية الأنساق الثقافية، لتبحر في النصّ، وتتبيّن المضمر، وتكتشف اللامعقول»، على حدّ إشارتها في مقدّمة الدراسة، ولعل هذا ما يفسّر كثرة المراجع التي تحيل إليها، وتنوّعها بين التاريخي والأدبي والنقدي والفلسفي والتربوي، ما يجعل نصّها النقدي يكتنز بمعلومات وفيرة وفوائد كثيرة. وهذه الإشارة إلى المنهج المعتمد يعبّر عنها العنوان الفرعي للكتاب بعبارة «دراسة ثقافية في الخطاب السردي»، غير أنّ المتن يشير إلى أنّ الدراسة تتناول الرواية الواحدة بمكوّنيها: الحكاية بما هي ماهية الحكي، والخطاب بما هو كيفية الحكي، لعلّها تكنّي بالجزء في العنوان عن الكلّ في المتن، أو لعلّها تصدّر عن فهم خاص لمصطلح «الخطاب».
نزاهة علمية
في تقديمه الكتاب، يتناول الأكاديمي الجزائري عبد القادر فيدوح الدارسة والدراسة، نتيجة معرفته بالأولى، وتأمّله في الثانية؛ فيشير إلى نزاهة المعدراني العلمية ووجاهتها النقدية، وهو ما يتمظهر في قيامها بـ»إحداث تطابق بين المتواليات السردية؛ المتماثلة مع مدركات أنساقها الثقافية، التي تتضمّن وقائع لتجربة اجتماعية واصفة، والكشف عن الذاكرة الجمعية لمعالم الهوية في لبنان، على وجه التحديد»، من جهة، ويصف الدراسة بأنّها «تنقيب مستفيض؛ بإعمال النظر في مضمرات النصّ، وعلاماته في منثنيات متعدّدة؛ بما يجاور نائيات المعاني، التي تسترسل دلالاتها الضمنية بدرجات متفاوتة في سموّ نزاهة بعض المواقف المقترنة بتماثل الهوية الآهلة في السرد، خاصّة حين تتماثل الكناية بالانزياح، بفعل تكاثف تشكّل سماتها الفنّية المتفاوتة»، من جهة ثانية.. وتأتي البحوث الأربعة في الكتاب، بما فيها من عمق التحليل، وصواب المقارنة، وكثرة الإحالات، وقراءة المقول، وتقصّي غير المقول، لتثبت صحّة الإشارة ودقّة الوصف.
تمظهرات متعدّدة
تتعدّد تمظهرات الهوية في الروايات المدروسة، وتختلف من رواية إلى أخرى؛ ففي «شريد المنازل» لجبور الدويهي، تتمخّض الدراسة عن اختزال الهوية بالبعد الديني، في المجتمع اللبناني. ذلك أن النسق الديني هو المهيمن في الرواية، بجناحيه الإسلامي والمسيحي اللذين يتقاسمان النفوذ في ما بينهما، ويرفضان أي خروج على هذا النسق، حتى إذا ما حاول ذلك بعضهم، أو أحدهم، تترتّب على محاولته نتائج وخيمة. وهو ما تخلص إليه المعدراني، من خلال اقتفاء سيرة بطل الرواية «نظام» الذي يشكّل نموذجاً لنسق بديل يحلم به السرد، غير أنّ اصطدامه بالنسق المهيمن يتمخّض عن انتصار الأخير؛ نظام ينتمي بالولادة لأسرة طرابلسية مسلمة، وينتمي بالتبنّي لأسرة زغرتاوية مسيحية، فتتشكّل هويته «من ماضٍ تمثّل بولادته، ومن حاضر تمثّل بوضعيته الحالية في حورا وعمادته»، ويتجاذبه انتماءان مختلفان، لكنّهما يجتمعان على رفضه «لأنّه، بقيمه، يمثّل تهديداً للنسق الطائفي بعامّة لا لفئة واحدة». ويتحوّل شريداً، «لا طرابلس تريده ولا حورا، فصار كأنّه مستبعد وملفوظ من المكانين، ما يجعل هويته الفردية المغايرة لكلّ الهويات مصدر قلق له، هي أداة لقتله لدى الطرفين». ويتمظهر هذا الرفض المزدوج في وقائع معيّنة، تنطلق منها الدارسة لتوجّه نقداً للحكاية بتصديرها عن منظور طائفي، يعلي الطائفة المسيحية على الإسلامية، من جهة، ونقداً للخطاب باعتبارها الشخصيات الروائية غير مقنعة، وقد «ركّبها السارد لتوافق منظوره الأيديولوجي، وليحقّق مآربه»، من جهة ثانية.
الآخر الغربي
«في بلاد الدخان» لهدى عيد، ترصد المعدراني الهوية المستلبة، جرّاء الاصطدام بين الذات اللبنانية والآخر الفرنسي، وهما نسقان مختلفان، مثقلان برواسب الماضي وأعطاب الحاضر وهواجس المستقبل، ذلك أنّ علاقة الزواج بين إبراهيم اللبناني وأرمال الفرنسية، وتمخّضها عن طفلتهما فرنسواز لم تفلح في ردم الفجوة التاريخية بين الطرفين؛ فأرمال التي تشعر بانتمائها إلى بيئة أرقى، وتحدّرها من جنس أعلى تحاول الاستحواذ على إبراهيم وإملاء قراراتها عليه مستخدمة الاستبداد الناعم، وتترجم شعورها الفوقي الذي يستبطن عنصرية عرقية ونظرة استشراقية، من خلال تفرّدها بتسمية الطفلة، ورفضها الإقامة في القرية اللبنانية، وعودتها إلى باريس مع ابنتها، من جهة، وإبراهيم الذي يأبى التبعية للآخر والتخلّي عن جذوره، يقرّر العودة إلى لبنان، ويرفض العودة إلى باريس، رغم عدم توافر مقومات المستقبل المضمون في الأول وتوافرها في الثانية، ولعله يصدر بذلك عن شعور وطني مشوب بشيء من الرومانسية الشرقية، من جهة ثانية. وعليه، يعيش استلاب الهوية، فيصبح موزّعاً بين البقاء في وطن لا يضمن مستقبله والتطلع إلى مغترب لا يناسب القيم التي نشأ عليها.
عدم الاعتراف
على أنّ أعطاب الهوية تتخذ تمظهراً آخر في رواية «قيد الدرس» للنا عبد الرحمن، يتعلق بعدم اعتراف الدولة بشريحة من مواطنيها، ممن يحملون هوية قيد الدرس، رغم انتمائهم إليها، ما يجعل وجودهم معلّقاً حتى إشعار آخر. وهو ما ترصده الدارسة من خلال اقتفاء تداعيات عدم الاعتراف على بطل الرواية باسم المولود لأب لبناني يعمل في فلسطين وأم فلسطينية، حتى إذا ما مات الأب، ولجأت الأم إلى لبنان في نكبة 1948، ونسيت أن تصطحب معها الوثيقة التي تثبت زواجها من لبناني، يتم حرمان الابن من جنسية أبيه. وبذلك، يجتمع عليه اليتم البيولوجي واليتم الوطني. على أن هذا العطب في الهوية، لا يقتصر على باسم بطل الرواية، بل يتعداه ليشمل سكان بلدة دير السرو من البدو، وتكون له تداعيات كثيرة عليهم، تستنتجها المعدراني من مجرى الأحداث، وتتراوح بين الهجرة، والالتحاق بمنظمة إرهابية، والانضمام إلى العمل الفدائي، والهروب من الواقع، والتحلّل من الواجبات الأسرية، والانحراف السلوكي، والاستلاب الوجودي والفكري والعقائدي.
وغير بعيد عن هذا العطب، ما تقرأه الدارسة في رواية «فاقد الهوية» لحنان فرحات، ذلك أن منيف، المولود في قرية لبنانية لأبوين لبنانيين، يُضطرّ إلى العمل في مدينة عكا الفلسطينية، حتى إذا ما عاد إلى وطنه بعد النكبة، ونسي أوراقه الثبوتية فيها، لا يتمّ الاعتراف بلبنانيته، ويكون عليه أن يعيش بلا هوية، وأن يدفع مع أولاده وأحفاده الأثمان الغالية، في مجتمع تكثر فيه عقد النقص، ويمارس أهله الفوقية، وتشوبه العنصرية الوطنية، فيعيش منيف غريباً في وطنه، ويحرم حفيده ناصر من الارتباط بحبيبته التي يُؤخذ أهلها بكلام الناس، فيرفضون زواجه من ابنتهم وتجاريهم هي في موقفهم. غير أن المفارق، في هذا السياق، أنّ كلاًّ من منيف وحفيده ناصر لم يفقدا الثقة بالنفس والشعور بالانتماء العربي، وبالتالي لم يتحوّلا إلى بطلين سلبيين. ولا بدّ من الإشارة، هنا، إلى أنّ الروايتين الأخيرتين تنفتحان على القضية الفلسطينية، وتشيان بالتداخل اللبناني الفلسطيني، واستطراداً العربي، في قضايا الانتماء والهوية. وهو ما تشير إليه المعدراني بوضوح في كلامها على الظلامة اللاحقة بالشعب الفلسطيني، منذ بدايات القرن الماضي، على الأقل، وتحمّل المسؤولية في ذلك إلى الآخر الغربي بتمظهراته المختلفة، الانتدابية والاستعمارية.
وبعد، لعلّ المشترك الأهم الذي يمكن الخروج به من الدراسة هو أنّ أبطال الروايات الأربع المدروسة، هم ضحايا الانتماءات المتعدّدة والهوية المفقودة، فنظام في «شريد المنازل» ضحية النسق الطائفي للنظام اللبناني، وإبراهيم في «في بلاد الدخان» ضحية العنصرية الغربية، وباسم في «قيد الدرس» وناصر في «فاقد الهوية» ضحيتا الحسابات الطائفية العنصرية الضيقة. أمّا الجلاد في هذه الروايات فهو واحد، على تعدّد مسمّياته، وهو الذات المتضخّمة الفاقدة للحس الإنساني.
تدوينة تابعتها الإشراق للكاتب سلمان زين الدين.
