16/11/2025
تقاریر 166 قراءة
التوتاليتارية صناعة غربية
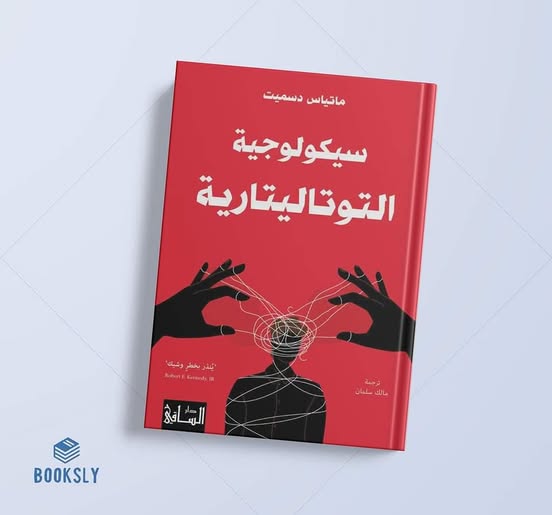
الاشراق
الاشراق | متابعة.
لم تولد التوتاليتارية من العدم، ولم تكن انحرافاً عرضياً في مسيرة الحداثة كما تحب أن تصوّرها الذاكرة الأوروبية، بل هي نتاج مباشر للعقل الغربي ذاته، بكل ما يحمله من نزعة إلى السيطرة والتوحيد والاختزال. إنها ليست كائناً غريباً غزا الغرب من الخارج، بل ثمرة داخلية لمشروعه الحضاري، تجلّت في السياسة كما في الاقتصاد، في التقنية كما في الفكر، في معسكرات الاعتقال كما في المصانع والمختبرات والشبكات الرقمية.
لقد أرادت الفلسفة الغربية منذ بدايتها أن تؤسس عالمًا عقلانيًا منظمًا يخضع لقوانين الفكر والقياس، فكان أن حوّلت هذا الطموح إلى أداة كونية للضبط والإخضاع. حين قال ديكارت إن الإنسان يجب أن يصير «سيدًا ومالكًا للطبيعة»، لم يكن يعلم أنه يفتح الطريق أمام نظام عالمي يحكمه مبدأ السيطرة الشاملة، حيث تُختزل الحياة كلها إلى أرقام، وتُدار المجتمعات كآلات. في هذا السياق، تصبح التوتاليتارية ليست نقيض الحداثة، بل وجهها الآخر: الوجه الذي يُظهر منطقها في أقصى تجلياته.
أولاً: الميتافيزيقا الغربية كأصل سياسي للتوتاليتارية
في قلب الميتافيزيقا الغربية يكمن هوس الوحدة والكلية. فمنذ أن وحّد أفلاطون بين الحقيقة والعقل، وجعل اللوغوس هو معيار الوجود، بدأ تاريخ طويل من القضاء على التعدد باسم الانسجام والنظام. العقل، الذي يفترض أنه أداة تحرير، أصبح مبدأ اختزال: يرفض الفوضى والغموض والتناقض، ويعمل على صهر المختلف في نموذج كلي متجانس.
هذا المنطق، الذي يبدو نظرياً في أصله، تحوّل في السياسة إلى نزعة توحيدية تبحث عن الدولة المطلقة والمجتمع المنضبط. فالمثالية التي حلمت بعالم عقلاني نظيف تحققت على الأرض في شكل أنظمة شمولية تسعى إلى إنتاج إنسان واحد، فكرة واحدة، وحقيقة واحدة. من جمهورية أفلاطون المثالية إلى دولة هيغل العقلانية إلى النظام البيروقراطي الحديث، الخطّ واحد: العقل يريد أن يحكم لا أن يفهم فقط.
إن التوتاليتارية، في جوهرها، هي تحقيق عملي للمثل الفلسفي الغربي: السيطرة الكاملة على الواقع باسم الحقيقة المطلقة. لذلك فإنها ليست انحرافاً عن الفلسفة، بل اكتمالها؛ وليست نقضاً للعقل، بل تحقق لمشيئته الهيمنية في مستوى السياسة والمجتمع.
ثانياً: الرأسمالية كنسخة اقتصادية للتوتاليتارية
حين اندلعت الثورة الصناعية في أوروبا، لم تكن مجرد حدث اقتصادي، بل كانت تحولاً أنطولوجياً في علاقة الإنسان بالعالم. فقد تحوّلت الأشياء إلى موارد، والأرض إلى مادة أولية، والإنسان إلى وظيفة في آلة كونية. الرأسمالية، في تعريفها الأعمق، ليست نظام إنتاج فحسب، بل منطق ذاتي التنظيم يقوم على «تثمين القيمة بذاتها»، أي على إنتاج لا غاية له سوى إعادة إنتاج ذاته.
بهذا المعنى، الرأسمالية هي توتاليتارية السوق: نظام يسعى إلى إدخال كل ما هو موجود في دائرة التبادل والاستهلاك. لا شيء يبقى خارجه: اللغة، الجسد، الفن، الطبيعة، وحتى الوعي الإنساني. كل شيء يُقاس بالثمن، وكل قيمة تُختزل إلى كمية قابلة للحساب. إنها عملية استعباد شاملة باسم الحرية، حيث يُستبدل القسر الخارجي بالإغراء الداخلي، وتتحول الرغبة نفسها إلى أداة للهيمنة.
لقد أدرك كارل ماركس مبكرًا أن الرأسمالية تحمل في داخلها قوة توحيد هائلة تمحو الحدود بين الشعوب والثقافات، لكنها تفعل ذلك بثمن باهظ: تدمير الإنسان والعالم معاً. فبدلاً من تحرير العامل من الاستغلال، حوّلته إلى ترسٍ في آلة عالمية. وهكذا انتقلت التوتاليتارية من الساحة السياسية إلى السوق، ومن الدولة إلى الشركة، ومن الشرطة السرية إلى لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي.
تعمل التقنية على توحيد العالم في لحظة واحدة: اللحظة التي يكون فيها الجميع متصلين ومتزامنين ومتشابهين. إنها تمحو المسافات والاختلافات وتخلق إنساناً شفافاً، قابلاً للقياس والملاحظة والتنبؤ. هذا ما يسميه بعض الفلاسفة «الإنسان السيبراني»
ثالثاً: التقنية كتجسيد للكلية
التقنية ليست أداة بريئة، بل هي تحقق ملموس للعقل الغربي في صورته الأكثر تجريداً. لقد تحوّل العقل إلى آلة، والمعرفة إلى نظام من الحساب والضبط، والإنسان إلى كائن رقمي تحكمه البيانات. العالم الرقمي اليوم هو الوجه الجديد للتوتاليتارية: لا قمع فيه ولا عنف، بل مراقبة ناعمة وامتثال طوعي.
تعمل التقنية على توحيد العالم في لحظة واحدة: اللحظة التي يكون فيها الجميع متصلين ومتزامنين ومتشابهين. إنها تمحو المسافات والاختلافات وتخلق إنساناً شفافاً، قابلاً للقياس والملاحظة والتنبؤ. هذا ما يسميه بعض الفلاسفة «الإنسان السيبراني» – كائن يعيش في فضاء افتراضي تتحكم فيه خوارزميات السوق والسلطة.
إنّ ما فعله ستالين وهتلر بالقوة والسلاح، تفعله التقنية اليوم بالإقناع والراحة: تزرع فينا حب الرقابة، وتحوّل الحرية إلى تفاعل، والرأي إلى بيانات، والمعرفة إلى إحصاء. لقد أصبحت التوتاليتارية اليوم بلا طغاة، لأن الآلة حلت محل الحاكم، والشبكة صارت الدولة الجديدة.
رابعاً: الغرب كحضارة السيطرة
حين يتحدّث جان فيولاك عن «أزمة الغرب»، فهو لا يقصد انهياراً مادياً أو اقتصادياً، بل انكشافاً للمنطق الذي صنع الغرب نفسه. الغرب هو أول من جعل من الكونية مشروعاً للسيطرة: من «الرسالة الحضارية» في الاستعمار، إلى «حقوق الإنسان» كأداة لتبرير التدخل، إلى «العولمة» التي تذيب كل ما هو محلي في السوق العالمية.
بهذا المعنى، التوتاليتارية هي الصناعة الأهم للغرب، لأنها تجسد فكرته عن التقدّم بوصفه إخضاعاً للطبيعة والإنسان معاً. إنها صناعة تتخذ أشكالاً متغيرة:
- في القرن العشرين، تجسدت في الأيديولوجيات الشمولية.
- في القرن الحادي والعشرين، تتجسد في العقل الأداتي والاقتصاد الرقمي.
الغرب لم ينتصر على التوتاليتارية النازية أو السوفياتية؛ لقد استوعبها وأعاد إنتاجها في شكل أكثر كفاءة. فالتحكم عبر السوق والشبكات ليس أقل شمولية من التحكم عبر الحزب والجيش، بل أكثر دقة وفاعلية، لأنه يعمل في صمت، ويُمارس باسم «الحرية» و«الابتكار».
خامساً: أزمة الإنسان في عصر الكلية
إنّ أخطر ما في التوتاليتارية الغربية أنها لم تعد تُمارس ضد الإنسان، بل من خلاله. فالإنسان الحديث صار هو نفسه أداة النظام، ينتج ويستهلك ويشارك طوعاً في إعادة إنتاج منظومة تلتهمه.
لقد فقد الإنسان معناه لأنه فقد حدوده: لم يعد ينتمي إلى مكان أو تقليد أو ذاكرة، بل إلى شبكة لا تعرف سوى الاتصال. لقد تحوّل إلى كائن شفاف بلا عمق، تحكمه الخوارزميات كما كانت تحكم الآلهة مصيره قديماً.
بهذا المعنى، التوتاليتارية ليست فقط نظاماً سياسياً، بل تحول أنطولوجي في بنية الإنسان نفسه: من كائن حر إلى وظيفة في جهاز. فحين يصبح العالم قابلاً للقياس الكامل، يفقد الإنسان أسراره وفرادته، وتنهار الحدود بين الفكر والآلة، بين الإرادة والتلقين، بين الحرية والبرمجة.
سادساً: إمكان المقاومة – التفكير ضد اللوغوس
رغم هذا التشخيص القاتم، لا يرى فيولاك أن الهزيمة حتمية. فكل نظام كلي يحمل في داخله شقوقاً تسمح بتسرّب الحرية. إن مقاومة التوتاليتارية لا تكون بثورة سياسية فقط، بل بثورة فكرية تتحرر من عبادة اللوغوس الواحد.
يدعو فيولاك إلى «تفكير متنافر» (pensée discordante) يعيد الاعتبار للاختلاف والصراع والتعدد، أي لما حاول العقل الغربي محوه باسم النظام. فبدلاً من توحيد العالم، ينبغي أن نتعلم كيف نعيش في التعدد، وكيف نحافظ على مناطق الغموض والسكوت واللامفكر فيه.
ليست الحرية، إذاً، هي غياب السلطة، بل هي القدرة على قول «لا» داخل نظام يقول للجميع «نعم». إن الخروج من التوتاليتارية يمر عبر استعادة المعنى، لا عبر الهروب من التقنية، بل عبر إعادة توجيهها لخدمة الإنسان لا العكس، عبر إعادة التفكير في حدود العقل نفسه، وفي قيمة التعدد كشرط للحياة.
خاتمة
التوتاليتارية هي المرآة المظلمة للعقل الغربي. لقد أراد هذا العقل أن يحرر الإنسان من الأسطورة، فإذا به يصنع أسطورته الخاصة: أسطورة السيطرة الكاملة. في سعيه إلى الحقيقة المطلقة، ألغى التعدد، وفي بحثه عن النظام، أنشأ الفوضى، وفي طموحه إلى الكونية، حوّل العالم إلى مصنع واحد.
إنها صناعة غربية بامتياز لأنها ولدت من إيمان الغرب بأن العقل قادر على تفسير كل شيء وتدبير كل شيء. وما لم يُعد الغرب، ومعه العالم كله، التفكير في هذا الإيمان نفسه، فسيظل ينتقل من توتاليتارية إلى أخرى: من السيف إلى الخوارزم، ومن الزعيم إلى الشاشة.
فالعقل الذي لا يعترف بحدوده يتحول إلى إله، والإله الذي يصنعه الإنسان سرعان ما يبتلعه. ولهذا، فإن معركة الإنسان اليوم ليست بين الديموقراطية والاستبداد فحسب، بل بين الحرية والعقل المطلق — بين الحياة بوصفها تعدداً مفتوحاً، والعقل بوصفه مصنعاً للكلية والمطابقة.
كريم حداد - كاتب
