14/10/2025
تقاریر 198 قراءة
بن أندرسون وآنا سكور..تسييس عواطف الجماهير
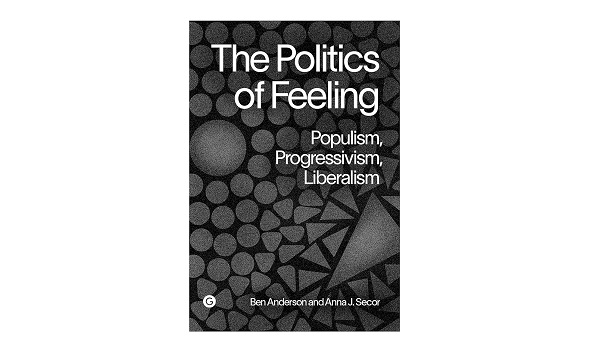
الاشراق
الاشراق | متابعة.
في أواخر القرن العشرين، بدأ الباحثون في العلوم الإنسانية والاجتماعية يلتفتون إلى ما أُهمِل طويلاً: العاطفة. فحدث ما سُمِّي لاحقاً بالمنعطف العاطفي، إذ أُدخلت العاطفة في تحليل الظواهر الثقافية والاجتماعية، وصارت في صميم التحليل ذاته. ومن هذا المنعطف وُلدت محاولة جديدة: فهم السياسة من خلال العاطفة، لا العاطفة من خلال السياسة.
صحيحٌ أن استثارة الجماهير بالمشاعر، بالخوف أو الحماسة أو الأمل، أمرٌ قديمٌ قِدم السياسة نفسها، لكن السؤال الذي يحرّك هذا الاتجاه ليس "كيف توظَّف العاطفة؟"، بل "مَن يُحدِّد مَن؟" ماذا لو لم تكن السياسة هي التي تحرّك العاطفة في المرحلة التي نعيشها اليوم؟ ماذا لو كانت العاطفة هي التي تُحرّك السياسة؟ وهذا لا يعني، في أيّ حالٍ من الأحوال، أن العاطفة جوهرية ونولَد بها، بل إنها، بصيرورتها التاريخية، أصبحت مبنية ومتجذّرة إلى درجة تجعلها محدِّدة للسياسة.
في هذا السياق يأتي كتاب بِن أندرسون وآنا سِكور "سياسة الشعور: الشعبوية، التقدّمية، الليبرالية" (منشورات غولدسميتس، 2025)، الذي يحاول تفسير التحولات السياسية المعاصرة من خلال مفهوم الشعور. ويطرح سؤال كيف تُلعب السياسة اليوم من خلال المشاعر السياسية؟ يرى المؤلفان أن السياسة المعاصرة لم تعد تُخاض عبر صراع برامج وأفكار (أيديولوجية) متماسكة، بل عبر العواطف: الغضب والسخط في الشعبوية اليمينية، الأمل واليأس في اليسار التقدمي، النوستالجيا والاعتدال في الليبرالية. المصيبة أن هذه العواطف لا تحمل برامج بديلة اليوم، بل هي أعراض مرضية لعاطفة جماعية راهنة تلغي أي إمكان للمستقبل. وهو بذلك يلتقي مع أطروحة فرانكو بيراردي عن "الإلغاء البطيء للمستقبل"، حيث تصبح الثقافة عاجزة عن تصوّر المستقبل، فنصبح معتادين على اجترار الراهن وعواطفه.
فماذا لو كانت هناك عواطف تدفعنا نحو أنظمة علمانية أو دينية، أو عواطف ترتبط باتجاهات فكرية مثل الليبرالية أو الماركسية، تجعلنا أكثر قابلية لتصديق وعود هذا التيار أو ذاك؟ في هذه الحالة، تصبح العاطفة المسيّسة سابقة على النظام السياسي الذي يستهدفها. وهكذا يتغير فهمنا للعاطفة التي تحركها السياسة، إذ تظهر عواطفنا على أنها مسيّسة منذ البداية، ومصاغة في إطار أشمل يتجاوز النظام السياسي المحدّد. فنحن نمتلك استعداداً عاطفياً لأن نكون ليبراليين أو ماركسيين مثلاً، وهذا الاستعداد قد يرتبط بنشأتنا، وتجاربنا، والسياسة التي أُخضعنا لها طويلاً، ومن ثم المنطق الذي طوّرناه والوعي الذي أصبحنا عليه. من هذا المنطلق، تُفهَم العاطفة بوصفها خلفية وجدانية لأي موقف سياسي ومن ثم هي تجسّد نوع الوعي (واللاوعي) الذي نحمله، وغالباً ما تكشف دراستها عن أبعاد يصعب الوصول إليها بوسائل أخرى.
كيف تُلعب السياسة اليوم من خلال المشاعر السياسية؟
ينظر الكتاب في العواطف التي تظهر في شكل شتيمة واستهزاء، غضب وخوف، حب وهيام، نفور واشمئزاز، أو حتى برود ولامبالاة، وتنعكس في خطابات سياسية معينة، ويرى أنها عواطف سياسية يمكن من خلال تحليلها أن نكشف محتوى سياسياً عميقاً. ولهذا حاججت الباحثة لوران بلان أن نظريات العاطفة تُعد امتداداً لنظريات الأيديولوجيا، وإن كانت لا تُختزَل إليها.
بالرغم من حداثة هذا التوجّه البحثي، فإن دراسة العاطفة السياسية ليست جديدة، لكنها لم تكن يوماً تياراً سائداً. تكشف الأدبيات أن الحسّ اليميني ارتبط بفكرة التراجيديا، من إدموند بيرك الذي قدّم رؤية تشاؤمية للتاريخ والثورات، إلى الفكر المحافظ عامة الذي يرى الشر جزءاً من طبيعة الإنسان، فيتبنّى نظرة تراجيدية للحياة، وصولاً إلى روجر سكروتون الذي يؤكد أن التاريخ مليء بالمآسي وأن التفاؤل الزائف يقود إلى الكوارث، وهو ما يفسّر تركيز جوردان بيترسون على التراجيديا مصدراً للحكمة. في المقابل، ارتبط الحسّ اليساري برؤية تفاؤلية ساخرة، تتجلى لدى ماركس الذي رأى في الكوميديا وعياً بالمأساة وتحويلها إلى نقد يمكّن من التقدّم، ولدى بريخت الذي استبدل بالتعاطف التراجيدي "تأثير التغريب" ليدفع الجمهور إلى التفكير عبر الضحك. وبمعزل عن التقليد الماركسي، انتقد اليسار النزعة البكائية واحتفى بالتعبير الفظ والساخر بوصفه لغة مقاومة قادرة على التغيير. لكن النمطين معاً تعرّضا للنقد حين سُطّحا وابتذلا. وقد وصف سلوتردايك النمط الثاني بـ"الكلبية"، مشيراً إلى أن الكلبية التي تأتي بعد الأيديولوجيا قد تكون أحياناً أكثر سذاجة منها، فهي شكل من أشكال "التضحية الساخرة"، والسخرية التي تهاجم الأيديولوجيات، ولاسيما الفاشية، قد تحمل في طياتها فاشية لا تقل خطورة. هكذا، تظهر العاطفة لا بوصفها استجابة وحسب، بل قوة فاعلة ومحدِّد ثقافي في عمق الفكر السياسي المعاصر.
وبرغم أن الكتاب موجّه أساساً إلى السياق الغربي، فالمفاهيم التي يطرحها يمكن نقلها إلى عالمنا العربي، الذي يعاني العاطفة السياسية في أكثر صورها تطرفاً. فالعاطفة السياسية حاضرة بقوة في مجتمعاتنا، سواء من خلال التصديق العاطفي لوعود سياسية زائفة، أو الانجذاب لشخصيات كاريزماتية سلطوية، أو التماهي مع خطاب سياسي ينبني على الخيبة والغضب. فكيف نصدق وعوداً سياسية بلا برنامج عملي؟ هنا تكمن قوة العاطفة: فهي تمنح السياسة جاذبيتها وسلطتها، لكنها تفسّر أيضاً لماذا يتحوّل البعض إلى التأييد أو المعارضة، ليس عن قناعة عقلانية ببدائل، بل بدافع إحباط أو سخط أو رغبة في انتزاع اعتراف. بهذا المعنى، العاطفة السياسية لا تقوم على الانقسامات وحسب، بل تنتج انقسامات جديدة، وتعيد تشكيل الحدود بين الناس وتوزيع الولاءات، فنجد تحالفات جديدة وانقسامات لم يكن ممكناً تصوّرها سابقاً.
تُختزل السياسة في صراع حول من يحق له أن يشعر وبأية طريقة
يستعيد الكتاب مفهوم "بُنى العاطفة" لريموند ويليامز، الذي يوضّح أن العاطفة ليست مجرد شعور شخصي، بل تجمع بين التجربة الفردية والجماعية، وتعكس القيم والمعتقدات والممارسات الاجتماعية. هذه البنى غالباً لا يُعبّر عنها بالكلمات أو القواعد الرسمية، فهي غير مرئية، لكنها حاضرة في حياتنا اليومية، العلاقات الشخصية، الأدب، الفنون، الموسيقى، وحتى في اللغة العامية. كما أن هذه البنى تتطوّر تاريخياً، فتتغير مع التحولات الاجتماعية والسياسية. ومن هنا تتجذّر العواطف، وتصبح سلطة قائمة بذاتها، يكفي أن تتكشّف قليلاً بطريقة الأداء حتى تُحرّك الفعل الاجتماعي. لذا، هي أدائية بشدّة، تقوم على الأداء، حركات الأيدي، الدموع، الشتيمة، الهتاف، المصطلحات العنيفة.
غير أن هذا الوضع يطرح مأزقاً عميقاً للبدائل السياسية. فالشعبوية تعد بالانفكاك من الأزمة لكنها تعلقنا بوعود غير قابلة للتحقق، بينما يقدم اليسار نقداً للحاضر من دون رؤية واضحة للمستقبل، وتلتفت الليبرالية إلى الماضي باعتباره ملاذاً، معيدة سرد ماضيها كأنه يحتوي الحل، لكنها تفشل في إنتاج الجديد. وهكذا تُختَزل السياسة إلى صراع حول من يحق له أن يشعر وبأية طريقة. هل تشعر بالحنق الكافي على السياسة؟ هل تدافع أو توبّخ أو تشتم بما يكفي؟ هل تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي لتثبت عاطفتك داخل جماعتك العاطفية؟ وحين لا تتوافق عاطفتك مع عاطفة الجماعة، يظهر رفض تعسفي للعاطفة على نمط "العاطفة الترامبية" وعبارة ترامب الشهيرة "تباً لعواطفهم"، حيث يصبح رفض العواطف نفسها والسخرية من عواطف الآخرين موقفاً سياسياً في حدّ ذاته. في النهاية، يخلص الكتاب إلى أن السياسة في عصر ما بعد الأيديولوجيا ليست مجرد صراع مصالح أو رؤى، بل صراع على، وداخل، البُنى العاطفية.
تقرير للكاتبة نور حريري - كاتبة ومترجمة سورية مقيمة في ألمانيا
